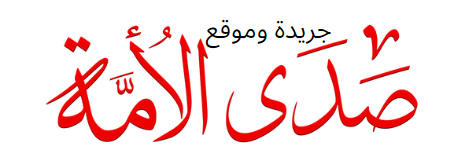البناء المفارقي في قصة "الأم الصغيرة" للقاصة سوسن حمدي محفوظ
بقلم د. سعيد محمد المنزلاوي
بين يدي النص
الكاتبة تسير في ذات المسار الذي انتهجته لنفسها، وهو الأدب المعبر عن المرأة في كل مرحلة من مراحل حياتها؛ حتى انمازت بهذا اللون الأدبي وبرزت فيه، في أسلوب يوصف بأنه من السهل الممتنع، حيث تنتقي مواقف من الواقع وتنقلها بحذافيرها كما هي في أسلوب سهل وبسيط، ولكنه قائم على المفارقة، والتي تكشف عوار الواقع، وتضع أيدينا على الأتون المتقد والذي تصطلي فيه الشخصيات في صمت أشبه بصمت أصحاب القبور، ولكنه ينطوي على كثير من الشروخ والتصدعات في أديم النفس البشرية المهترئة من واقع لا تجد فيه المرأة التقدير اللازم لها.
والمكان ـ هنا ـ غير محدد، ينسحب على رقعة عريضة من مجتمعنا حيث الأسرة المتوسطة، والتي تمثل رقعة عريضة من نسيج هذا الوطن. بينما ينسحب الزمان على الماضي والحاضر على حد سواء، فبالرغم من تطور الحياة من حولنا، إلا أن النظرة القديمة للأنثى لا تزال لها الهيمنة داخل بيوتنا وعقولنا.
المحاور الرئيسة:
1- التعصب للذكر في المجتمع الشرقي.
2- مرض الأم وأثره في تطور شخصية البنت.
تنماز القصص الاجتماعية الشرقية عن نظيرها الغربي، في تباين نظرة المجتمع الشرقي إلى الذكر والأنثى، العضوين الرئيسين في كل أسرة. فبينما لا نجد فرقًا يذكر بينهما عند المجتمعات الغربية، تغلب النظرة المتعصبة للذكر في المجتمعات الشرقية على اختلاف الثقافات والبيئات والمستويات الاجتماعية.
وتظهر هذه النظرة المتعصبة للذكر في هذا الاستهلال الموفق:
"لطالما كانت رسوماتي محط سخرية أخي الأكبر، كان كثير الاستهزاء بها وبألوانها، بينما كانت والدتي تثني عليها وتشجعني، وتأتي إلي بكل ما أطلبه من ألوان وأوراق".
هنا تظهر النظرة الذكورية والتعالي من قبل الذكر (الأخ الأكبر)، في تنمره بموهبة أخته الصغيرة.
ذلك التنمر هو الذي يضع أيدينا على بؤرة الحدث، الذي يدور أساسًا حول التمييز بين الولد والبنت، وتنتقل عدوى هذه النظرة بعد ذلك من الأخ الأكبر إلى الأم؛ " كانت أمي تنفذ لأخي كل ما يطلبه، لكنها تتلكأ أحيانا كثيرة فيما أطلبه أنا ما عدا الألوان والأوراق". " كانت تمنح أخي كل ما يطلب دون مناقشة، وحين كنا نتشاجر سويًّا من أجل لعبة أو شيء ما كان الأمر يحسم في النهاية لصالحه ".
هناك نظرة دونية للبنت (الأنثى)، وتمييز للولد (الذكر) عليها، وتسيطر هذه النظرة على رقعة الحدث، وتلازم شخصياتها، بالرغم من تطور بعض الشخصيات.
ثم يتفجر الحدث الأعمق في تغيير مجريات الأحداث وتوجه الشخصيات، وهو مرض أمها المفاجئ، وملازمتها الفراش، فتصبح الطفلة ذات العشر سنين مسئولة عن المنزل، وباتت أمور المنزل كلها من اختصاصها وحدها، دون مساعدة من أخيها أو حتى أبيها. وهنا تبرز هيمنة المجتمع الذكوري، والتمييز بين اختصاصات كل من الذكر والأنثى فيه؛ فهي ولأول مرة" بين الأواني والأكواب وحدها، تقف أمام الموقد لا تعرف أي الأزرار يجب الضغط عليها لإشعال النيران لتجهيز الطعام "، بينما أخوها "جلّ ما يفعله هو مشاهدة التلفاز ولعب الكرة في الشارع".
بين الوعي واللاوعي
"على حافة سرير أمي الغائبة عن الوعي منذ أسبوع أو يزيد، كنت أتناول يدها الباردة المعروقة وأبكي..أنادي عليها سرًا وجهرًا بأن لا تتركنا وترحل، أخبرها أني لست حزينة منها لأنها تحب أخي أكثر مني، وأني لن أطلب منها المزيد من اللعب، وسأترك لها شعري في الصباح تفعل به ما يحلو لها دون صياح أو شجار، بل سأساعدها في أعمال المنزل وإحضار الطلبات من السوق، فقط لو تستيقظ".
تحمل الفقرة السابقة على عاتقها بؤرة الحدث ومحاوره الرئيسة، والتي تتفتق عن معاناة هذه الطفلة الصغيرة، التي تحولت بين عيشة وضحاها إلى "أم" مسئولة عن أمها المريضة وأبيها وأخيها، بل وعن مستقبلها ونجاحها وتفوقها، وتنم كذلك عن شعورها بالدونية في مجتمع ذكوري يميز الولد على البنت، ولكنها، بالرغم من مرارة هذا الشعور، إلا أنها تقبلته، فلا مندوحة لها على الاعتراض أو التمرد أو الرفض والإباء. وهذا التسليم ربما بسبب مرض أمها، الذي لا يحتمل معه أية مواجهات أو مشاحنات.
وبالرغم من تحملها لمسئولية البيت وأمها المريضة، إلا أن ذلك لم يحل دون تحصيل دروسها:
- "ذاكرت رغمًا عني واجتهدت قدر الإمكان"
لتظهر بعدها النتيجة بعد ذلك، فتحتل هي المركز الثاني علي فصلها بينما أخوها ينجح ولكن بدرجات ضعيفة.
إن اختلاف مستوى الأخ عن أخته راجع لتلك التربية الخاطئة، والتي تميز في التعامل بين الأبناء، فتتساهل مع الولد تساهلًا، أدى به إلى التأخر الدراسي، والانسياق وراء اللعب واللهو، ولم ينجح ذلك في استدار حبه، أو تحمله المسئولية، فقد جفت لديه منابع الحب، وبدت عليه السلبية واللامبالاة.
البناء المفارقي للشخصيات:
الأم: تحمل الأم نحو ابنتها عاطفتين متناقضتين: فبينما تثني عليها وتشجعها، وتأتي لها بكل ما تطلبه من ألوان وأوراق؛ لكنها تتلكأ أحيانا كثيرة فيما تطلبه، في حين "كانت تمنح أخي كل ما يطلب دون مناقشة".
ثم يظهر انحيازها لأخيها "حين كنا نتشاجر سويًّا من أجل لعبة أو شيء ما كان الأمر يحسم في النهاية لصالحه".
الأب: يسير في القصة من مبدئها لنهايتها على تيمة واحدة، وهي الانحياز المطلق للولد، والتجاهل المطلق للبنت، وكأنها غير موجودة، فهو لم يبال بموعد امتحاناتها إلا عندما ذكرته ليقوم بإيقاظها في الصباح، ولم يسعد بتفوقها، ولم يعدها بهدية كما وعد أخاها، كما أنه لم يقدر تضحيتها العظيمة، عندما قامت بدور الأم عندما مرضت أمها. وهذا التجاهل من قبل الأب يضع العديد من علامات الاستفهام عن أبعاد هذه النظرة الدونية للفتاة، ولكنها تزول بملاحظة شخصية أخيها، والتي تنشَّأ لتقوم بذات الدور الذي يقوم به الأب، وكأنه انعكاس له ورجع الصدى.
الولد: يظهر بشكل ثابت كشخصية غير مهتمة بالدراسة، مما يثير تساؤلات حول تأثير التربية على شخصيته، فحياته تنحصر بين لعب الكرة خارج المنزل، ومشاهدته للتلفاز داخله، فتعود الانسحاب للخارج، فلم يعنيه البيت، ولا الجلوس بجانب أمه المريضة.، وهذا الجانب السلبي لدى الولد، نجده كذلك لدى الوالد، والذي لم نجد له أثرًا ملموسًا في التعامل مع الزوجة المريضة أو مواساتها.
البنت: هي الشخصية الرئيسة والمحورية، تتسم بالمثالية والتضحية، وانكار الذات. موهبتها الرسم، بما يمثله من محاكاة للواقع، وتجسيده بالفرشاة والألوان على الورق، وهو نفس الدور الذي قامت به في الواقع، وهو محاكاة دور الأم، بعد مرضها.
إن التحدي الذي واجه تلك الشخصية المحورية؛ هو رعاية الأم والنهوض بأعباء المنزل ـ بجانب موهبتها ودراستها ـ بالرغم من حداثة سنها، وقلة خبرتها.
وكما كانت الألوان والأوراق هما عالمها السري لدنيا أخرى لا يحكمها أحد سواها؛ باتت أمور المنزل كلها من اختصاصها وحدها.
إن التحولات التي طرأت على حياتها عندما تولت مسئوليات المنزل بعد مرض والدتها، جعلها أسرع نضجًا؛ فتعلمت مهارات جديدة وتحملت مسئوليات أكبر، مما ساهم في نموها وتطورها كنوع من النضج المبكر. كما أنها لم تتوقف عن حبها الفطري لوالدتها رغم تمييز الأم أخاها عليها.
معلمة الاقتصاد المنزلي: والتي تمثل بصيص الأمل للبنت الصغيرة، "جعلت المعلمة تنظر إلي من تحت نظارتها وهي تطلق صيحات الدهشة والإعجاب، لتصفق لي وهي تبتسم قائلة : - براااافو، شطووووورة. ثم أمرت الجميع أن يصفقوا لي."
كما كانت خير داعم لها، حيث " صار بيننا نوع اَخر من التعليم في الفسحة وأثناء الحصص الاحتياطي، حيث كانت معلمتي تأخذني إلى حجرة الاقتصاد المنزلي وتقوم بتعليمي بعض الأطعمة الجديدة".
إن الدعم الذي قدمته معلمة الاقتصاد المنزلي، ساعدها على اكتساب الثقة بالنفس والقدرة على التعامل مع التحديات الجديدة.
البناء المفارقي للنص
تنهض القصة على البناء المفارقي، الذي يقوم على ثنائية الشيء وضده، المنح والسلب، العطاء والفقد، مما يشكل لونًا من الصراع يثري النص، ويفك الكثير من شفراته، ويسلط الضوء على دخيلة الشخصيات، ويفسر الكثير من سلوكياتها. ومن هذه المفارقات، التي تفصح عن نماذج الشخصيات ودخيلتها اختلاف موهبة كل من البنت وأخيها، فحين كانت موهبتها الرسم "لم يكن لأخي موهبة يقضي فيها وقت فراغه سوى لعب الكرة ومشاهدة التلفاز".
ومن مفارقات عدم التقدير أنها تقوم بكل شئون المنزل والمطبخ إلا أن أحدًا لم يثنِ عليها؛ بينما أخوها الذي جلّ ما يفعله هو مشاهدة التلفاز ولعب الكرة في الشارع. لا تكف والدته عن السؤال عنه وعن سبب تأخره.
ومن المفارقات التي تنهض على ثنائية الخذلان والجبر خذلان الخالات والعمات والجارات، واللاتي كنَّ "يَقْدمن لزيارة أمها المريضة، وتقوم إحداهن بين الحين والآخر بالدخول إلى المطبخ لإنجاز ما تيسر لها من العمل، ثم يتركنها بين تلك الأواني والأكواب وحدها، لا تدري ماذا تفعل"؛ ساعدتها معلمة الاقتصاد المنزلي في المدرسة في اكتسابها بعض الخبرات، "حيث كانت معلمتي تأخذني إلى حجرة الاقتصاد المنزلي وتقوم بتعليمي بعض الأطعمة الجديدة".
ومن المفارقات التي تظهر في سفور التعصب للذكر على الأنثى، حين "حلّ موعد اختبارات نهاية العام.. التي علم والدها موعدها بالكاد طلبت منه ضرورة إيقاظها مبكرًا، وعندما تكاسل أخوها عن الذهاب للامتحان، وعده والده بهدية كبيرة لو نجح وحصل على المركز الأول فيذهب مرغمًا، دون اجتهاد منه في المذاكرة. وكأن نجاحها لا يعني أباها من قريب أو بعيد، فالذي يعنيه نجاح ولده وفقط.
مفارقة لاذعة
تختتم الكاتبة قصتها بهذه المفارقة اللاذعة، والتي تحمل من القسوة والمرارة أضعاف ما مر من مفارقات في ثنايا النص.
"عندما تحسنت صحة الأم قليلًا، وباتت تعي ما حولها، نادت على ابنها في سعادة بالغة وهي تبتسم وتحتضنه بيدين مرتعشتين، وتبارك له نجاحه الذي كانت تدعو له به في مرضها". الابن وكأنه قد من صخر؛ يبتسم ولا يرد، تحاول استبقاءه بجانبها لكنه يريد مغادرتها؛ ليلعب.
بينما تهوي شهادتها على الأرض، والتي وضعتها بالأمس تحت المخدة لتكون أول ما تراه أمها حين تفيق وتستيقظ، ويقع معها تلك الوريقات الملونة التي جاءت كلها بمشهد واحد، حيث احتل وجهها العذب كل مساحات الورقة البيضاء ومعها كتبت كلمة: (أحبك يا أمي).
بهذه الجملة الأخيرة، يسدل الستار على تلك المأساة، والتي تعيشها بكل شجاعة تلك الطفلة ذات الأعوام العشرة، إنها بالرغم من تلاقيه في بيتها من الدونية وعدم التقدير، إلا أنها تحب أمها، وكأن هذه الطفلة، قد نضجت لتصبح بين عشية وضحاها أمًا لأمها المريضة، متغاضية عن التجاهل وعدم التقدير، لكنها بالرغم من كل ذلك لا تملك إلا أن تحبها، بالرغم من وأد طفولتها، وعدم تقديرها، وتمييز أخيها عليها، إن قلبها كقلب الأم، فلا تعرف إلا المسامحة والحب وإنكار الذات. إنها حين نهضت بدور الأم، اكتست معه ثوب الأمومة ولم تنفك عنه.
وهنا تبرز مفارقة المشاعر لدى البطلة وشعورها بالإهمال أحيانًا من قبل والدتها التي تظهر اهتمامًا أكبر بأخيها، ولكنها في الوقت نفسه تظهر حبًا وتفانيًا كبيرًا لوالدتها عندما تمرض. هذا التناقض في المشاعر يضيف عمقًا نفسيًا للشخصية يجعلنا نتعاطف معها.
ما سكت عنه النص
نجحت الكاتبة في تصوير المشاعر الإنسانية والصراعات الداخلية للشخصيات فنجد أن احتفاء الأم بنجاح أخيها على الرغم من درجاته الضعيفة، بينما البطلة تحتل المركز الثاني في فصلها، لم تلقَ أي تقدير من أسرتها، إنما يُبرز غياب العدالة في التعامل داخل الأسرة.
وهذه رسالة القصة التي تسطرها وهي النظرة الدونية للأنثى زوجة كانت أو ابنة أو أختًا أو أمًا، وكأن جرمها في الحياة أنها أنثى، أنثى بلا وزن أو قيمة أو ثمن.
وبالرغم من مثالية شخصية البنت، إلا أن أمرًا مثل هذا تنجم عنه عواقب لا يحمد عقباها، سكت عنها النص، واكتفت الكاتبة بالإشارة الخاطفة لها، ممثلًا في سقوط شهادتها وأوراق الرسم ومعها كلمة "أحبك يا أمي".
وهذه النهاية للأحداث، إيعاز ببداية لأحداث جديدة، يمكن أن تتحول فيها مشاعر البنت بسبب التجاهل والإنكار الذي لاقته من جميع أفراد أسرتها. إن القصة تحمل رسالة تحذير بالغة الأهمية، فحواها أن الكبت يمكن أن يتولد عنه انفجار، وأن مشاعر الحب توشك أن تنقلب بين عشية وضحاها إلى كره ونفور.