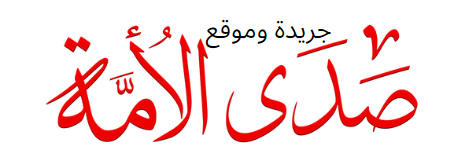أنثوية القصة قراءة في قصة "كبد الحقيقة" للأديبة "سهير إدريس"
بقلم د. سعيد محمد المنزلاوي
تقديم:
سهير إدريس، أديبة متميزة وفريدة، تتحدث الإنجليزية والفرنسية بطلاقة، تكتب الشعر والقصة القصيرة، بجانب كونها أوبرالية ومحاضرة قديرة. صدر لها ديوانان «عناق الدار»، و«حضن العراء»، يتميز عالمها الأدبي بالثراء، وتداخل الأجناس الأدبية، والذي ينم عن ثقافة عريضة متعددة الروافد، فهي أديبة من العيار الثقيل، ولها حضور مؤثر في الندوات الثقافية والصالونات الأدبية.
بين يدي النص
حين تمسك بالقلم، من تجيد العزف على أوتار الكلمات، من تمتح من معين التراث، من تجيد التحليق بلغة شعرية، من تكسو الكلمات ثوبًا فضفاضًا، تتسع رقعته لتداخل الأجناس، وتفاعلها، لتمازجها وتآلفها، من تملك المقدرة على الغوص وراء الكلمات؛ لاستخراج دررها ونفائسها، واستدرار كوامنها، من تضرب بعصاها فتفجر في الكلمات إيحاء نشوانًا وحياة نابضة، ترقى بالمعنى وتسمو بالإحساس. إذن فنحن أمام حالة أدبية خاصة، وموهبة إبداعية متميزة.
والآن مع تلك الدرة الأدبية، والأديبة الدرة.
هذا النص
هذا النص عالم قائم بذاته، محكم البناء، واسع الثراء، فهو سردية مفعمة بالثراء اللغوي والمعرفي مع امتلاك أدوات القص، وتطعيمها بلغة الشعر؛ ليبحر القارئ بين دفتي السرد والتناص، إلى أن يصل إلى نهاية الرحلة، فتصدمه المفارقة السردية للخاتمة، فيعاود الإبحار مرة ثانية وثالثة، وفي كل مرة يبحر، يعود بالجواهر اللغوية، واللآلئ البلاغية، ثم يتوقف من جديد أمام الخاتمة؛ والتي تفك شفرات النص، فيعاود الكرة مرات ومرات؛ ليبلغ كبد الحقيقة، وما هو ببالغه، لكنه لا يسأم ولا يمل.
عتبة العنوان
يجمع العنوان بين متضايفين: أحدهما ينتمي إلى عالم الجسد، وهو "الكبد"، والآخر ينتمي إلى المجردات، وهو "الحقيقة". والتي ترادف الصدق في توافقها مع الواقع، وكبد الحقيقة: صلبها؛ فالعنوان تعبير مجازي يعني أن شخصًا وصل إلى جوهر الحقيقة أو فهمها بشكل كامل.
فالاستعارة تبدأ من عتبة العنوان؛ حيث جعل للحقيقة كبدًا من باب الاستعارة، مما يعني أننا أمام عملية كشف للمضمون، وبيان للحقيقة، وسفور عن وجهها دون تزييف أو خداع.
بين يد النص
القصة عبارة عن حُلم، فأين الحقيقة في الأحلام؛ كي نصيبَ كبدها؟ ولكنَّ الأحلام تترجم عن واقع الحياة؛ بين ما نعيشه، وما ننشده، بين ما هو كائن، وما هو مأمول.
إن كثيرًا من رغباتنا، إن لم تتحقق في اليقظة، فإن لها في عالم الأحلام السحري أرضًا خصبة؛ حيث لا مستحيل هناك، وليس شيء بعيد عن المنال.
لكنْ ما إن يذهب النوم، تنقشع غلالة اللاوعي؛ ليستيقظ الوعي على واقعه الذي رفضه، وحياته التي أنفها ويأباها.
فعمر "الحُلم" قصير جدًا إذا ما قورن بعدد ساعات النوم، فما بالك بسنوات العمر!
الافتتاحية:
"كان متهدجًا ذاتَ مساء في مصباحِ ألمِه الدُرّىّ، يصارع أمواجَ الصخب، مترنمًا في تسابيحها الهوجاء الغائصة في مراقد الزَلل، والدمع يتقطرُ من عيونٍ أرّقها الغيابُ ووحشةُ الفراق"
بهذه اللغة الشاعرة الساحرة افتتحت القاصة حكايتها، لنلج معها هذا العالم الصاخب؛ حيث حشدت القاصة كل صور الشوق والمعاناة والأسى؛ وبتلك البداية الصوتية الأسيانة للنص، استهلت القاصة سرديتها وهي تمتح من معين القرآن الكريم من سورة النور؛ فالصوت متهدج، متقطع في ارتعاش واضطراب، وهو يصارع أمواج الصخب، ويسيل الدمع لشعوره بالوحدة والوحشة معًا.
وتتوالى النداءات المحمومة:
- أين أنتِ يا مهجة الروح؟
- أين السبيل إلى مساكن اللقاء ومنافذ الاحتواء؟
تنم تلك النداءات عن شدة الشوق ولهفته للقاءٍ أشبه ما يكون بالمستحيل.
وتحمل جملة الاستهلال أكثر من عنصر، والذي سار عليه النص من مبدئه لمنتهاه.
فنجد التناص، واللغة الشاعرية، والبناء الاستعاري، تسير جنبًا إلى جنب مع البناء السردي المحكم للقصة.
وهذه هي المحاور الأربعة التي انتهجتها للولوج إلى عالم النص، وسبر أغواره، والوقوف على خصائصه ومراميه.
محور التناص
بين يدي العَجْز
"لم أكن ذلك المحب الذي تهواه أفانين عشقِها المرمري".
بعد هذه الجملة تحشد القاصة مبررات عجزها بجملة من معجزات الأنبياء، وغيرهم ممن ورد ذكرهم في القرآن الكريم، والتي تنم عن ثقافة واسعة، ومقدرة عالية على توظيف التراث والتزواج بين التراث والمعاصرة.
- لم أكن أمتلك عصا موسى لتغيير مسار الهوية وتذليل مصائب الدهر.
- لم أكن يونس لأحتمي ببطن الحوت وأفرّ من المجهول.
- لم أكن آصِفَ لتفسير مسمى هذا الحدث المروّع.
- لم أكن كنعانَ يلهو عاصيًا آويًا لجبلٍ يعصمه من الماء كي نغرقَ سويًا كعُصاةٍ لكن أحباء.
ويأتي التناص القرآني في جملة "لا تحاصرني كذئب" مستدعية قصة "يوسف" عليه السلام مع إخوته.
كما يأتي الاقتباس القرآني في جملة (فهل ثَمّةَ ولوجٌ لجمل في سَمّ الخِياط؟)، والتي يحتمل أن يقصد بها الجمل (الحيوان المعروف)، والذي يتناسب مع ذكر (الذئب)، والذي يحتمل كذلك المعنى الثاني وهو (الخيط الغليظ) ويرشح هذا المعنى مع جاء ذكره بعدها في جملة "انزعي رداءً دنِس الكِبر"، وهذه براعة تضاف إلى رصيد القاصة حيث وظفت التفسيرين للنص القرآني بما يجعلهما دالين على المعنى المراد، دون انحياز لتفسير دون الآخر.
كما يأتي التناص في جملة (باخع القلب) باستبدال القلب بالنفس؛ لتعبر بذلك عن أن الهلاك للقلب بسبب الوجد والعشق، واختيارها للقلب لأنه موطن الحب، والخطاب على لسان الزوجة/الواقع
ويستدعي التناص الأدبي في جملة (وبرمقة زرقاء اليمامة في حدتها)،"زرقاء اليمامة" تلك الشخصية التراثية بما عرف عنها من مقدرة على التنبؤ واكتشاف الخطر قبل وقوعه، والتنبه إليه. وذلك في وصفها لتلك الحبيبة، والتي "تحتمى بثيابٍ فضفاضةٍ تخترقُ كلَّ اتجاهات البوصلة بخطواتٍ مهندمةٍ في نعالٍ فادحةٍ كصهيلٍ يشقُّ آذان الرابضين".
وحين تستدعي الذات "حكمة سليمان"؛ فإن ذلك لتذليل جماجم مطامحها، وحين تأمل لولوج الجمل في سم الخياط؛ فإن ذلك الرجاء كي ترضخ لنداء قلبه، ومن ثم كان من أبرز صفات تلك التي يناجيها الكِبر، وكان هو صاديًا يبحث عن آبار الارتواء، ولذا كان توسله أن تنزع رداءً دنِس الكِبر، وأن تشاطر فنجانًا أسيرًا، يلثم شِفاهًا جَفاها الرحيق. ولكي يصل إلى تلك المرأة التي وصفها بأنها "عنيدة" تمنى لو امتلك خاتم "سليمان"؛ ليحوز قلبها.
المعادل الموضوعي
تمثل الأميرة (الحبيبة) معادلًا موضوعيًّا للمرأة التي يتوقها؛ حيث يأتي الحلم والخيال في مقابل الحقيقة والواقع. فالحبيبة كما وصفها، هي "الغازيةِ لمكامن قلبي ونوارس أنسي صائدةِ القلوب، وهي "الأميرةِ المتوجةِ على عرش الأفئدة". بينما الزوجة تصفه بأنه "صهر مواجعي ومِلح مدامعي، خائنَ العشرةِ وباخعَ القلبِ" وبأنه "الجاحدُ روافدَ الوصال قاطبة"، وهذه الصفات هي ما يشعر به نحوها.
البنية الحوارية
تنهض البنية الحوارية بين شدٍّ وجذب وتدور بينهما رحى الحوار، هو يريدها لتطبيبِ وجيعته وإزاحةِ ثِقَلٍ أدمى مقصده، بينما هي في بوتقة آمالها لا تبالي بنقيق حزنِه المخيّم على شفق منهلها.
وفي غمرة يأسه منها يطلب منها أن تنصرف، ولكنها تخبره بأنها لا تستطيع، فتساوره الحيرةُ وتعصف به الشكوك، ويتساءل بينه وبين نفسه: هل "تحبني وتكابر؟ هل تتخذ العناد نهجًا تنهجه؟ أم إنها قد صارت لَعوبةً بعواطفي تؤرجحني يمينًا وتعيدنى يسارًا؟" ويرجوها ثانية أن تنصرف، أن تدعه وشأنه، فلم يكن واقعه بهيجًا كعالم الأحلام، إنه يعاني "تباريح الانهزام وشراشفِ الأشجان"، كما أن "عروشُ نخله خاويةٌ أصابها وهجُ افتقارٍ"، بل غزا الشيب رأسه.
اللغة الشاعرة:
وأول ما يلفت النظر في القصة اللغة الشاعرة، فالكاتبة تلمس أثر الكلمة ووقعها وجرسها؛ فاللغة شاعرية، والإيقاع يجنح بك في عوالم من السحر والخيال والجمال
ومن هذه التعبيرات الشاعرية، التي نمقت بها قصتها والتي تنهض على تعرج بنا في مسارات شتى ما بين معجم الحزن والموت، ومعجم الطبيعة في لغة استعارية بديعة، فنجد:
- رداء دنس الكبر.
- وهج افتقار.
- بريق ينادي هيامي التائه.
- نقيق حزنِك المخيّم على شفق منهلي.
- أمواجَ الصخب.
- مراقد الزَلل.
- ومنافذ الاحتواء.
- طواحين المرار.
- عشقِها المرمري.
- جماجمِ مطامحك.
- رواق أعاصير خواطري.
- خارت مجاديفي.
- أدمى مقصدي.
- بوتقة آمالي.
- تباريح الانهزام.
- وشراشفِ الأشجان.
- تأرّجَ الفجرُ.
وغيرها الكثير، مما يجعلنا أمام لوحة فنية بديعة الصور، مجنحة الخيال.
كما تستخدم القاصة تستخدم لغة فوق اللغة، بمفردات غير دارجة، بالرغم من فصاحتها، مما يدل على موسوعيتها المعجمية والمعرفية معًا، ومنها لفظة (مهباجها) وهي مدقة كبيرة، (جرن خشبي) لطحن القهوة. وقد اشتقت تسمية المهباج من كلمة هبج والتي تعني في لسان العرب (هبج يهبج هبجا) أي ضرب ضربًا متتابعًا فيه رخاوة والهبج الضرب بالخشب
هل أصاب كبِد الحقيقة؟
ما كان كبد الحقيقة إلا ذلك البريق الذي اخترق مقلته؛ فتابعه "فإذا بها تتدلى بتاجها المزركش كأنها أميرة الدلال مضمخةً بهذا الثمِل الولهان وبرمقةِ زرقاءِ اليمامة في حِدّتها، تحتمى بثيابٍ فضفاضةٍ تخترقُ كلَّ اتجاهات البوصلة بخطواتٍ مهندمةٍ في نعالٍ فادحةٍ كصهيلٍ يشقُّ آذان الرابضين".
إن كبد الحقيقة بالنسبة لديه يعني بلوغَها والوصولَ إليهاـ وأنها ليست وهمًا، وإنما من لحم ودم، وتفوق في دلها ودلالها كل النساء.
لكنه عندما استدعاها، أتت على غير إرادتها وهي في وضعية قَوسِ قزح. إشارة إلى إحدى تمارين اليوجا، وفي نفس الوقت تبطن هذه الإشارة إلى قوس قزح، كونها ـ كقوس قزح ـ وهمًا وخداعًا فلا وجود لها في الواقع.
ولذا سألها: "هل أنتِ هي أم ذلك هاجسٌ قد اعتراني، أم لعلى امتلكتُ خاتم سليمان"، فكان جوابها الذي أكد كونها وهمًا، لا وجود له إلا في خياله هو فحسب، كما لم يكن لمهباجها صدى إلا على رأسه وقلبه؛ حتى خارت مجاديفه واختلت موازينه.
"فنظرتُ إليها والتقطتُ أنفاسي المنهكة من هول المفاجأة، هل الهيام والوحي أحن علىّ من هاتِهِ الغازيةِ لمكامن قلبي ونوارس أنسي صائدةِ القلوب، ولا زالت كل المشاهد والأحداث متعاطفةً معي إلا قلبُ هذه الأميرةِ المتوجةِ على عرش الأفئدة". إنه ينشد المحال، وليس إلى بلوغه منال.
المفارقة السردية
وفي مرحلة الانتقال من النوم إلى اليقظة، والهبوط من مطية الأحلام إلى أرض الواقع، في هذه المسافة البينية بينهما، تتداخل ثلاثة أصوات؛ فيسمع صوت شخص آخر على مقربة منهما يقول:
- لا لن أنصرف، كيف أتركك في سويعاتِ الليل وآنائِه؟
وكأن الخطاب كان موجهًا لهذا الآخر، وليس لسيدة الدلال.
ويهتز بوخزة يدٍ بعيدةٍ عنه، ويعاوده الصوتُ مرة ثانيةً:
- كيف أترككَ وأنت تثرثر طوالَ هذا المساء حتى تأرّجَ الفجرُ وَضَاءَ النهارُ بازغًا، قم استيقِظ من منامك خائنَ العشرةِ وباخعَ القلبِ حتى صار كدميةٍ رثيثةٍ لا قيمةَ لها، أيها الجاحدُ روافدَ الوصال قاطبة، لم أكن حبيبتَك، أنا زوجتك.
وهنا أسقط في يده، لقد ولجت زوجُه حُلمَه حين غفا؛ ليتم ضبطه متلبسًا بحلمه ونجواه لأميرته. وتضع زوجه النهاية بما يشبه الصدمة:
- لقد أفشيتُ سرّك في جُنحِ الظلام واختلاسةِ المنام، هذا صنيعكَ العجيب سيدى أسيرَ الغرام.
والسؤال الذي يطن طنين النحل: أين كبد الحقيقة فيما سبق؟
إنَّ دخول زوجه له في الحلم لتوقظه على الحقيقة الموجعة ليفيق من حلم بمن يتمنى أن يعيش معها إلى زوجه الصاخبة، التي يفر منها إلى عالم الخيال.
- لم أكن حبيبتك، أنا زوجتك.
- والفارق جَدُّ كبير بين أن تكون زوجة وبين أن تكون حبيبة.
فالنهاية صادمة، مباغتة، تم البناء والتمهيد لها جيدًا من خلال تيمتين، هما: رمزية الحلم، ورمزية الأميرة. وتكون المفاجأة (خاتمة النص) بمفارقة يستوي فيها القارئ والحالم على حد سواء، فتكون حبيبته التي يناجيها إنما هي زوجه التي توقظه بوخزاتها؛ حين استحال الغرام في اليقظة، راح يبحث عنه في نومه، وحين غابت ملامح العاشقة في زوجه، راح يفتش عنها في مخيلته، لكنه في النهاية يفيق على واقعه الأليم.
وختامًا
القصة أنثى، والأنثى قصة
لقد تجلت ملامح الأنثى في هذه القصة، حيث أديرت الأحدث من وجهة نظر أنثوية بحتة؛ فالزوجة لا تقبل أن يشاركها في زوجها أحد، بل لا تقبل أن يشرد خياله فيفكر بغيرها، ولو كان ذلك في الحلم.
كما تبدو أنثوية القصة في تلك الزخارف والمنمنمات التي وشت بها الكاتبة قصتها البديعة؛ فخرجت في أبهى زينة، وكأنها شكلت قصتها من أديم الزهور، أو نسجت خيوطها من قوس قزح، حتى يكاد يختلط الأمر على المتلقي، هل ما يقرؤه قصة أو قصيدة أم محكي شعري؟ وذلك براعة تضاف للقاصة، في نصها الفريد وكأنه فرائد السماء انتظمت في عقد من السرد الشعري، الموشى بالمحسنات البديعية، دون
أن تشعر بسأم وأنت تنتقل بين أفيائه الظليلة.