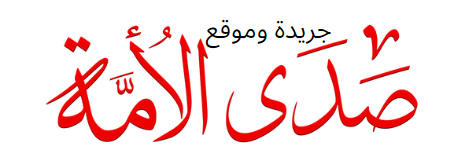المعارضة الشعرية بين المحاكاة والإبداع PDF
بقلم: د. طارق عتريس أبو حطب
أمين عام ائتلاف الشعراء والمبدعين العرب
لعل مفهوم " المعارضة " يمثل مصطلحا شعريا هاما من مصطلحات الشعر التي فرضت نفسها بقوة على ساحاتنا الأدبية في العصر الحديث مع ظهور الحركات الأدبية المتعددة لاسيما مدرسة " المحافظين " أو أنصار القديم من الشعراء الذين تعصبوا لكل ما هو تليد وأنكروا كل محاولة لتغيير التراث بداية من ظهور ما يسمى بمدرسة " الإحياء والبعث " على يد " البارودى ".ويقصد بمفهوم " المعارضة " "أن يقول شاعر قصيدة في موضوع ما، فيقوم شاعر آخر، وينظم قصيدة أخرى على نهج هذه القصيدة، في وزنها وقافيتها وموضوعها ". فالمعارضة قائمة - إذن - على وجود نموذج فني ماثل أمام الشاعر المعارض، لينتهج نهجه، ويحاكيه، أو يحاول التفوق على من يعارصه.
لم تكن " المعارضة " موجودة في الشعر الجاهلي وذلك لسبب بسيط وهو أن :- لأن النموذج الشعري الذي من المفترض أن يحاكيه الشاعر الجاهلي لم يكن معلوما ،ولهذا السبب فإن " المعارضة " تعتبر بصورة أو بأخرى معبرة عن مفهوم الشعر وطرائق إنتاجه في نظر أنصار القديم من رواد مدرسة " الكلاسيكية " وهو المفهوم القائم على استلهام التراث الشعري العربي القديم في مراحل قوته وازدهاره وتميزه وما صحب ذلك من فحولة وجزالة على يد شعراء العربية الكبار من الفحول أمثال " البحتري وأبي تمام وأبي نواس والمتنبي وابن الرومي والمعري والبوصيري والحصري القيرواني وغيرهم " .
ولا يمثل هذا النوع من القصائد - أعني المعارضات - إلا جانبا من جوانب ارتباط الشعراء بالقديم ومظهرا جلياً من مظاهر تأثيرهم به على أصعدة مختلفة كما تمثل إمعانا منهم في استظهار وحفظ التراث العربي القديم والإقبال عليه رغبة منهم في التميز والخلود وحرصا على تحقيق نوع من أنواع التفاعل الإلهامي مع الموروث وتحقيق التواصل بين القديم والحديث، وتتحقق " المعارضة " عن طريق جانبين أساسيين هما جانب خاص بذاتية الشاعر وتجربته الشعرية الخاصة والمنفصلة عن النص الذي يعارضه فنياً و تاريخيا والجانب الثاني خاص بذاكرة الشاعر الحافظة الواعية،حيث تلعب تلك الذاكرة دورا أساسيا في تشكيل بنية النص المعارض،ومن منظور نفسي لا تعني المعارضة المواجهة الصريحة " بقدر ما يبدو الموقف مطروحا من خلال هذا المنظور النفسي للشاعر وتعتبر المعارضة فن أدبي. فهي قراءة خاصة يقوم بها المبدع للنص الغائب،فهي عملية إبداعية تتم -وفقاً لرأي بعض النقاد - من خلال ثلاثة أسس هي الاجترار والامتصاص والحوار و يكون النّص الحاضر استمراراً للنص الغائب، وإعادة له إعادة محاكاة وتصوير، ويتلخّص عمل المؤلف هنا في أن يقدّم إلينا النص الغائب في أوزان شعرية و"الامتصاص" هو قبول للنص الغائب وتقديس له وإعادة كتابته بطريقة لا تمسّ جوهره، وينطلق المؤلف هنا من قناعة راسخة، وهي أنّ هذا النص غير قابل للنقد أو الحوار، فإن الحوار يكون نقداً للنص الغائب، وتخريبا لكلّ مفاهيمه المتخلّفة، وتفجير له، وإفراغه من بنياته المثالية، وهو لا يقبل المهادنة، فهو أعلى درجات التناص وأرقاها ، وهذا الأساس هو الذي تبرز من خلاله مقدرة الشاعر وقدرته على بعث نص جديد قادر على الحياة والتفاعل مع غيره من النصوص السابقة عليه والتالية له، فالشاعر الجديد يستحضر الشاعر القديم نصا وتجربة عبر نصه داخلا معه في منافسة من نوع خاص،لكنه لا يتوقف -غالبا - عند حدود بنية النص السابق،بل نجده يعيد بناءه مضيفا للنص القديم حياة جديدة.وخلاصة الأمر أن المعارضة لقاء شعري بين شاعرين لم يجمعهما المكان ولا الزمان،ولكن جمعتهما حالة شعورية واحدة منتجة لنص يتولد عنه حالة أخرى تجمع بين الجدة أما فنية المعارضة، فموضع خلاف بين الباحثين، حيث نالت -خاصة معارضات شوقي- قسطا وافر من الهجوم قديما وحديثا،يكفي أن نشير في هذا الإطار إلى معارضات شوقي وما نالته من هجوم من قبل نقاد معاصرين له مثل طه حسين وآخرين حداثيين من مثل أدونيس وكمال أبي ديب ومحمد بنيس.
أما فنية المعارضات فقد كاننت- ولا زالت - موضع خلاف شدبد بين نقاد الأدب فيترك ذلك لموضعه على طاولة النقاش والدراسات الأدبية دفعا الملل.